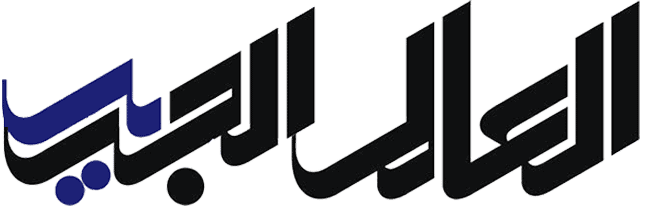ونحن نواجه، اليوم، أسئلةً كبرى تدور في الرؤوس بلا أجوبة، وتطالعنا علامات التعجّب في كل مكان، تضاعفت مرارات العيش في أجواء الحروب، وصار الموتُ شبحاً يُطارد الناس في هذه المنطقة، ويُنغّص حياتهم بظلال أجنحته التي لا تتوقّف عن الرفيف فوق رؤوسهم. ويبقون، في ظل هذه الأجواء، خائفين من احتمال وقوع ما هو أسوأ في أيامهم القادمة، وكأن ما يُقال عن انفراج الغمامة بعد حينٍ أمرٌ لا يعنيهم، وليس في وارد أقدارهم التي صارت ، لتعاقب الأزمات المستمرة، من حتميات وجودهم في هذا المكان. ويحدث ما لا يحصى من البشاعات، دون أن يكون هناك اهتمام أو مبالاة بما تتركه من آثار مرّوعة في مجتمعات هذه المنطقة، كما لو أن العقل والعقلاء صاروا رهائن في قبضات آلهة جديدة للتوّحش، وشركاء بجبروتهم وقدراتهم اللامحدودة، التي لا يُوقف أحدٌ شرورها المتنامية ، في التحكّم بحياة الناس ومصائرهم.
بعد كل ما آلت إليه نظم الثقافة والحضارة من “تقدّم” في هذا العالم، نكتشف، خارج ما تضعه مؤسسات الأديان، والعقائد، والمرويات ذات النهايات السعيدة، من صورٍ للفراديس الأرضية والسماوية، بأن نسبة كبيرة من ميول البشر مازالت خاضعة لنداء الغاب البعيد، الذي ينطلق من صورة الصياد والطريدة. وهناك قوى فاعلة تُنشّط غرائز النزاع، والدفاع عن البقاء، لدى الأفراد والجماعات، على حساب مبادئ العيش المشترك فيما بينهم، حيث يزداد الإبتعاد عن منطق العقل، وسوّية السلوك، لصالح تلك الميول اللاعقلانية. كما أن رموز هذه القوى مازالوا يتحكّمون بنتاجات العقل، ويروّضون لسلوك الأفراد في المجتمع، حتى الشفقة التي يُبديها كثرٌ من هؤلاء على الضعفاء من أبناء جنسهم، غالباً ما تكون بدافع تميّيز مظاهر قوتهم بالتعامل مع الوضع الأدنى لغيرهم، ويتمنون أن يبقى هذا الوضع على نفس المستوى من تراتبية العلاقة المختّلة. ولا يطمحون، حقيقة نفوسهم، إلى علاقة وديّة مع من يماثلونهم في المنزلة والنفوذ، وإذ يُظهرون بعض التعاطف معهم، فهو من باب الرياء الاجتماعي، والنفاق الوظيفي. ويتجلى ذلك بوضوح في عالم السياسة، حيث البحث عن الأتباع والمريدين، الأضعف فكراً والأقل قدرةً على التفكير، في دائرة الأقلية المهيمنة على الحكم والحزب وحتى الجماعة الصغيرة.
إن المثال الأقوى على التفاعل التصاعدي مع تلك الميول، هو استمرار النزاعات الدموية على مساحات واسعة في منطقتنا، وارتكاب المجازر التي تجاوزت المواجهة بين الأعداء التقليديين ، لتكون أكثر وحشية ضد الأبرياء العزل، المشغولين بسّد الرمق وشظف العيش. ويُمارس كل ذلك، بدمٍ بارد، وبلا مبالاة شبه عامة، كأن ما يحدث جزءاً من مشهدية الحياة الاعتيادية.
كيف تحدث كل هذه الأفعال التدميرية في ظل العقل الذي أرشّف نتائج الحروب السابقة، وصور الموت والدمار التي ظلت ندوباً متقيّحة في ذاكرة التاريخ؟ هل صحيحٌ ما يُقال بأن العقول في منطقتنا قد تعطّلت، وباتت عاجزة عن مواجهة غرائز التدمير المتنامية فيها، وأن العقل الغربي قد سيطر على تلك النوازع، واستبدلها بمشاعر إنسانية لن تجد تلك النوازع فيها مجالاً تتفاعل فيه، ولن يحدث ما يجعلها تفرّغ طاقاتها السلبية الدفينة في أعماق النفوس؟
لا يمكن لأحد الشك بأن العقل – بمعنى العلاقة بالمكان وليس التكوين البايولوجي – في المجتمعات الغربية قد أنجز الكثير في مجالات العلوم، والتكنلوجيا، وتقنيات الإتصال، وثورة المعلومات الكبرى، وصحّت عليها تسمية “مجتمعات المعرفة”، ولكن ما يجعل الأمر مأساوياً، هو أن المعرفة نفسها بيّنت لنا بأن نظم هذه المجتمعات الغربية لم تجعل العقل سلاحاً للبشرية في هذا العالم الذي سموّه “قرية صغيرة”، يُحارب هيمنة نوازع الشر التي تنتج اليوم حقولاً واسعة للموت في مناطق الحروب المجنونة، بل أن النخب السياسية والعسكرية التي تحكم هذه المجتمعات هي التي تعمل على صناعة الأزمات والحروب وإدارتها بشكلٍ صار مفضوحاً أمام الجميع . كما أن المعلومات التي أصبح من الصعب السيطرة على تدفقها ، توضّح لنا بالصورة عن عمليات قتل وحشيّة تحدث بين فترة وأخرى في مدن هذه المجتمعات، ممن أطلق عليهم توصيف “الذئاب المستوحدة”، فضلاً عن قيام الكثير من الأفراد بسلب ونهب الممتلكات أثناء حدوث الكوارث الطبيعة، وانتشار ظاهرة تجنيد الشباب من غير الأجانب للعمل في تنظيم داعش . وليس آخراً ، صعود بعض الجماعات اليمينية – النازية التي تدعو لنقاء العِرق، وإقصاء المنتمين لديانات وأعراق أخرى. بمعنىّ آخر، إن قوة قوانين السلطة في هذه المجتمعات، لا سلطة العقل أو الرادع الأخلاقي، هي من يحدّ من انتشار هذه الميول والممارسات ، وجعلها شغّالةً على مساحاتٍ ضيقة داخل المجتمع.
لقد ركّزت هذه النظم نتاجات العقل التقنية في حدود مجتمعاتها، وجعلت من العقل مُنتِجاً للأسلحة التي تُديم تلك الحروب، وتنشّط أسباب الصراع في مناطق الموت البعيدة عن أراضيها، بل وتعمل على تدوير نفاياتها – أسلحة متراكمة في المستودعات، ومرتزقة مهمّشين تحت دوران عجلة استهلاكها، أو قادمين من تخوم الفقر التي تستفرغهم أفواجاً خارج حدودها – في مناطق التوترات المستدامة، ولكي يتم استهلاك هذه النفايات بدوافع السيطرة والربح، لابد لتلك النظم من البحث عن قوى تُديم حركة انسيابها في ممرات المتنازعين، فكانت مهنة تجّار الحروب هي القوة التي تحافظ على استمرار لعبة الموت. وعليها أن تجد العقول الملائمة لقيادة الاحتراب وتصعيد وتيرته، ولا أفضل لها من عملية النبش في أنقاض تاريخنا للبحث عن مفاهيم الاختلاف التي تُثير جذور العداء وتُغذيّها في تلك العقول.
وهذا ما حصل في ولادة تنظيم القاعدة، والتنظيم الأكثر دموية في تاريخنا الحديث، داعش، بمعنى آخر، إن نظم رأس المال الاستهلاكي تريد إعادة انتاج نفايات تاريخنا، لتكون بيئة صالحة لإعادة تدوير نفايات منتجاتهم لأغراض الكسب والربح المفرط، ونشهد اليوم عملاً مثابراً على إشاعة المفاهيم والأفكار المولّدة للتخلّف، وتشغيل الفائض الإنتاجي الغربي في المناطق التي تعبث بها أدوات التخلّف والخراب، متمثّلة بمؤسسات الفساد، وقوى الإرهاب في منطقتنا.
وهنا، يتبادر للذهن سؤالٌ حول مدى الأهلية الإنسانية للعقل في هذه المجتمعات التي مرّت بأطوار مختلفة من من التنوير، والنظريات العلمية المتراكمة، والمفاهيم الديمقراطية، ووصلت إلى هذا المستوى من الحداثة الفائقة؟ وكيف يمكن لمن يمتلك هذا النوع من العقل أن يوظف ملكاته الذهنية في ممارسات تسبب الضرر للبشرية بأشكالٍ مفرطة في لاعقلانيتها؟
ما شهده العالم من دمار في حربين عالميتين خلّفتا الكثيرمن الفواجع والمآسي في حياة الشعوب، وأظهر مديات من الوحشية لم يسبق لها مثيل في تاريخ الجنس البشري، خصوصاً ما جرى في أفران الغاز النازية التي كانت مهرجانات جماعية لشواء البشر، على مرأى من العقل الغربي، وخصوصاً الألماني، وهو الوريث الأقوى للفكر والفن والفلسفة، يُثير الكثير من الأسئلة الصادمة التي تشكّكُ بدور العقل البشري في مواجهة النوازع التدميرية التي حدثت في الماضي، وعدم الإفادة من دروس التاريخ التي دوّنت جرائم تلك النوازع، ووثّقتها بالصورة والصوت. وها هي المآسي البشرية تتكرّر بأشكالٍ أشدّ بشاعة وترويعاً في طريقة استهداف حياة المدنيين العزل، وتحويل مدنهم ومنازلهم إلى أنقاض وخرائب، مثلما يحدث اليوم في اليمن التي تُدمّر وتُحاصر، ويُجوّع شعبها، وتفتك به الكوليرا، إلى حدّ أن البعض هناك راحوا يتغيّرون وفق تحولات بايولوجية معكوسة، وأخذوا يمشون على أربعة أطراف ، صار لها ، من شدّة الضمور، شكل القصب اليابس . كل ذلك يحصل للشعب اليمني تحت غطاءٍ من صواريخ وقذائف تُمطر ناراً على أرضهم . ومن يصنع هذا الجحيم، ويُمزّق أجساد أبناء هذا البلد العربي ذي العمق التاريخي المعروف، يطلقون على أنفسهم اسماً يُناقض تماماً بشاعة فعلتهم: “قوات التحالف العربي”!. والأكثر بشاعة أن هناك الكثير من دول “العالم الديمقراطي”، سليلة النهضة والتنوير العقلاني الأول تقوم بتسويغ هذه الجريمة، وجرائم أخرى كثيرة، بالدعم أو الصمت. وهاهم إرهابيو القرن الحادي والعشرين ينحرون رقاب الناس في الساحات العامة التي كانت متنزّهات للترفيه ، ويدمرّون مدنٍ بأكملها ، ويسبيون النساء ، ويغتصبون الأطفال ، تحت أنظار عقول ” العالم المتحضّر”. وصرنا نتعامل مع تلك البشاعات كصورٍ يُمكن مشاهدتها خلال وجبات الطعام ، أو التفرّج عليها كفديوهاتٍ جيدة الإخراج لتسليات المساء، وتزجية وقت الفراغ !!
أيّ عالمٍ هذا جعل العاطفة البشرية بهذه الدرجة من الجمود ، واللامبالاة ، إزاء ما يحدث من ويلاتٍ ومواجع تعصف بحياة البشر، بلا رحمةٍ أو رأفة؟ وكيف ستكون أشكال البشر في المستقبل إذا ما استمر التاريخ ، كما هو حاله الآن، غارقاً في الحروب، ودورات العنف المتواصلة ، والاستهلاك الجنوني، والتحوّل بطرقٍ مشوّهة إلى “مزبلة للبيولوجيا”، حيث الأقوى يفرض شروطه المُلزمة للبقاء وتدمير كل ما يقف في مواجهة قوته، والعقل يُراقب ما يحدث مكتفياً بدور المتفرّج الأخرس؟
لا أحد يدري أيّة أنواع من النفايات ستظهر في حقب التاريخ القادمة، وكيف ستكون المصائر التي تنتظر البشر، والعقلُ مازال حصاناً يركبه حوذيُ غرائز أعمى في طريقٍ مجهول.