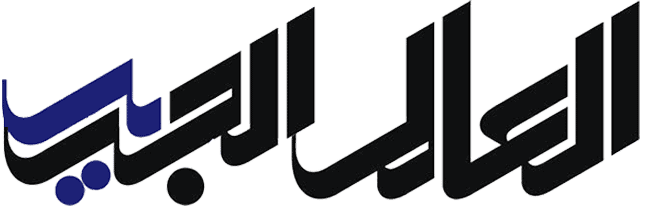في أجواء الاضطراب والفوضى التي يصنعها اللاعبون الجدد بالمصائر البشرية، ومن ينوب عنهم من متسلقي حبال الوصولية المتعدّدة الأشكال، يتّسع عالم المتاهة الذي ينسجون خطوطه المتداخلة على وفق أساليب صراعهم الجديدة، ومصالحهم المتجدّدة، ويُدخلون فيه العديد ممن وهنت عقولهم، واضطربت نفوسهم تحت قسوة وضبابية تلك الأجواء، حيث يجدون أنفسهم، منزوعي الإرادة، على خطوط تلك المتاهة بلا بوصلة أو دليلٍ للنجاة.
إن ما يجعل المرء مسيّراً بإرادت أخرى، وبلا قدرة على اتخاذ موقف أو رأي مغاير، هو عمق الاختلال في منظومته القيمية، الأخلاقية والنفسيّة، والتحكّم بها وفق معايير صارمة من نظمٍ وجماعات تضع موجهاتها الأيديولوجية، ومنافعها الخاصة، فوق كل القيّم والأخلاق، ولا تريد لحياة الأفراد شكلاً يُغاير ما تفكّربه، وتخطّط له، على مدار ساعتها الموجهة بأوهام السلطة، وتسلّط وحش المال.
إن التغيّب المستمر لصوت الضمير الإنساني في متاهة هؤلاء اللاعبين، وألاعيب قرودهم التي تمتد اليوم إلى مساحات واسعة من أرضنا وهي تصنع المزيد من المتاهات المفروضة بإرادة الأقوى، تنشط الكثير من النظم العابرة للمفاهيم الإنسانية، والمحبطة لأحلام الناس وآمالهم. نظم لا علاقة لها بمشاعر التعاطف الإنساني، ولا بحق الناس في صناعة حياتهم، هذه الحياة التي تتحوّل، في الظلال القاتمة لتلك الأجواء، إلى مواضعٍ مُهمَلة تتغوّل بين جدرانها نوازع العزلة والشعور بالتهميش، وتفرض على من يعيشون بينها حواجز نفسية تضخّم حالات النكوص والانكفاء في نفوسهم، وتجعلهم مستوحدين في مواجهة العالم من حولهم، وبعيدين عن روح التفاعل الايجابي معواقعهم اليومي الذي يتم تحويله إلى جحيمٍ مسّتعر تتلظى فيه النفوس الحائرة.
وهنا، نرى اليوم الكثيرين ممن يهربون من هذا الواقع المرير إلى عوالم افتراضية، تصنعها لهم شاشات صغيرة تلمع في تلك المواضع المهملة التي صارت ملاذاً يقيهم إشكالات الواقع والتباساته.
هم يحرّكون أرتال الدبابات، والصواريخ الموجهة، والقاصفات المدمرّة، في الفضاء وعلى الأرض، لنرى نحن، في عزلاتنا، صور الدمار الذي تسببه للبشروالعمران، وكيف تتحوّل حياة الناس والمدن، خلال ساعاتٍ قليلة، إلى أنقاضٍ وأشلاءٍ بشرية مبعثّرة على الطرقات .فتخيّل كيف يكون وضع الناس، وخصوصاً ممن يعيشون في مناطق الأحداث، وهم يُشاهدون ويعيشون كل هذا الخراب بإرادة معطّلة لا تحرّك ساكناً لتجنبه، سوى رفع درجات الانفعال إلى أقصى مستوياتها، والعيش تحت سوء التوقعات ومخاطر ما هو مقبل، والهروب غير الآمن تحت ظلال الخوف لمن تتاح لهم فرصة نجاة منتزعة من براثن الإرهابيين والقتلة.
لهم حق افتراض ما يُريدون بحسابات مدروسة، تتحوّل في لحظاتٍخاطفة إلى أفعالٍ يحركها ريموت حواسيبهم، ولنا قبول أفعالهم، وبشاعتها، لأن حواسيب مواضعنا المهملة مخصّصة لافتراضٍ منزوع الواقع، ولصورٍ متنوّعة توجد أشكالها الحيّة على بعد مئات أو آلاف الأميال . ونحن لا نعرف حدود الخطأ والصواب فيما يُنقل لبعضٍ منها بحساب المصالح أو الأهواء.
فهل تحوّلت الشاشات التي يتحكّم بها أباطرة الميديا الحديثة، وهم يتناغمون بالتبعية، وفروض الخدمة مع اللاعبين ” الكبار ” بحمولاتهم الثقيلة من السلطة والمال، إلى عالم افتراضي متحرّك يصنع واقعاً جديداً، يسحب الناس إلى نسخٍ معدّلة من واقعهم الفعلي الذي لم يعد مرغوباً العيش في شبكاته المتداخلة، وفوضى ما يحدث فيه، حيث تتضاعف القوى الضاغطة على حياة المجتمعات (ابتداءً من وسائل الصراعات العنفية وليس انتهاءً بالتجدّد اللامحدود للاحتياجات في ظل معدلات الفقر المتصاعدة) وزيادة الضغوط اليومية على الأفراد (عائلة، بطالة، تقدّم في العمر مصحوب بالإهمال، تعدد الرؤى وسيل المعلومات الجارف في عقول الشباب المستنّفرة) وبذلك يجعلون الناس يحلقّون في فضاءات أخرى خارج حقائق الواقع الفعلي، تُزيّن فيها مشاهد برّاقة جمال الطبيعة، وتعرض ما لذّ وطاب من الطعام، وآخر موضات الأزياء، وإعادة تشكيل أعضاء الأجساد حسب الطلب والمواصفات. وعندما يصحوا الفقراء على واقعهم اليومي، بعد أن يستيقظوا من تأثير صور أحلامهم الإلكترونية، لا يجدون سوى سقوف الغرف الواطئة، وفراغ الأرواح الذي يخلقه هذا التداخل والالتباس بين ما هو موجود على الأرض، وما هو افتراضي على الشاشات الملوّنة.
لقد أصبحت شاشة الحاسوب في البيت، وشاشة الموبايل في كل زاويةومكان، الوسيلة الأكثر استعمالاً في التواصل مع الآخرين لأغراض العملوالدراسة، وحتى الصداقات القريبة التي كانت تنمو وتزدهر باللقاءات الحميمة والمنتظمة، قد تأثّرت بطبيعة تعقيدات الحياة الجديدة المخلّة بصفاء القلوب، وطمأنينة النفوس، وأصبح جزءٌ كبير من تفاعلها في ضمن عالم هذه الشاشات الذي تختار فيه الوقت المناسب لمزاجك وظروف عملك، والذي لا يكلفك تحمّل مشاق الطريق، ومخاطره في ظل ظروفٍ أمنية ونفسية صارت بالغة الخطورة والتعقيد . ولا ندري إن كان في تفكير هذا العالم مهمة تصنيع لعبة جديدة لـ(بوكيمون الصداقة) تقوم بتسهّيل عملية البحث عن الإصدقاء الذين صارت لكل منهم زاويته المغلقة في متاهات هذه الحياة. حيث يكون بمقدورمن يرغب بتحقيق لقاء مع صديق، بعد فترةغياب أو نسيان !! تشغيل نظام (جي. بي. أس)، والقيام بالبحث عن هذا الصديق و”قنصه”، وهو مسترخٍ بخذلان الذاكرة في زاويته المغلقة، وربما لا يكون في حسابه مثل هذا اللقاء المفاجئ والمبرمج، فيغلق برنامج اللعبة في شاشته بحجة انقطاع التيار الكهربائي أو ضعف الشبكة. هكذا تخيّلت هذه اللعبة من منظور (سايكو – فكشن) له تداعياته الكثيرة في واقعنا اليوم، وله الأكثر من توليد الأوهام في الأذهان المضطربة التي تتضاعف بمرور الوقت، وسرعة الدوامات المتتالية التي باتت تضغط الوقت والتفكير لمنع بعض الحلول الممكنة، قبل أن تتراكم تلك الدوّامات وتصبح صعبة التفكيك، وليس من السهل مواجهة تداعياتها المستمرة.
على المثقف الذي لا يريد أن يخسر ضميره، ويقف عارياً بصمته في زحمة الأحداث والتجاوزات على المفاهيم الإنسانية، أن يضع كل هذه التعقيدات والمآسي التي تفتك بحياة الناس على طاولة أفكاره المكشوفة لعيون الآخرين، وأن لا يغمض عينيه على ما تسببه من مواجع وآلام، بل يكون صريحاً وجريئاً في الإشارة إليها، وبيان طبيعة المخاطر التي تتعرض لها الحياة نفسها نتيجة استمرارها، وتراكمها المتواصل، دونكشفها والتأكيد على العمل في تغيير مساراتها المعقّدة.
لقد فقدت الكثير من القوى والشخصيات، خصوصاً في مجال العمل السياسي، صدقيتها، ومسخت الملامح التي كانت تدلُّ عليها، بسذاجة ما تفكّر به، وضعف القدرة في مواكبة الأحداث والتأثير في تشكلاتها ومآلاتها التي باتت غريبة على نمطيّة تفكيرها، وأحكامها المسبّقة . وهي في واقعها هذا، صارت جزءاً من التعقيدات والمآسي، ولهذا ينبغي، أيضاً، تعرّية ضعفها وأوهامها، لكي يتحّرر عقل من ظل رهينة في شراك مسلماتها، ويكون بإمكانه أن يفكر بطريقة أخرى، ويُعيد حساباته على وفق ما يواجهه من وقائع وأحداث تلامس حياته، وتستدعي أساليب جديدة يتم بناؤها بضوء ولادة رؤى مختلفة لا تخضع لتلك المسلمات .رؤىّ تتقاطع معما صار متهرءاً من تصورات سابقة، وآراءٍ تكنسها مستجدات الأحداث، وهي تفرض أنماطاً جديدة للعيش والتفكير. وفي مثل هذا الواقع الملتبس، ليس هناك خيار غير التمرّد على المهيمنات الفكرية الموروثة، والعمل على طرائق للتغيير تناسب تلك الولادات والرؤى المختلفة.
وفي خضّم المعمعمة التي تسود هذه الأجواء، يحاول البعض القفز فوق عوارض الحاضر بعكازةٍ ملّونة بصور الماضي، معتقداً بأنه، بهذه القفزات، سيتخلص من تأثير ما يواجهه في واقعه اليومي من أزماتٍ بلا حلول، وبأنه سيفتحنوافذ جديدة تطلّ على عالمٍ مختلف، هو المستقبل الذي يتمنّاه له ولمن يحب، دون تكلفة أو خسارة على مذبح الحاضر.
نعم، نحن نحتاج إلى الحفاظ على ذاكراتنا وحماية موجوداتها وصورها الجميلة من إهمال التقادم، ونكران ظواهر أزمنة مختلفة، ولكن ذلك لن يحصل في الهروب من الحاضر، بل في خلق مساحة جديدة لتحرير العقل من الأوهام، ومواجهة وقائع الحاضر المأساوية بنوعٍ من التفاعل الذي يدفعنا للتفكير بكيفية الخروج من شراكها التي ينصبها من يريد إيهامنا، والتحكّم بمصائرنا. وبذلك سيكون لصور ذاكراتنا الجميلة دور إيجابي يساعدنا على التماسك في تلك المواجهة التي تُخرجنا من شرنقات عزلاتنا المغلقة إلى فضاءات الحياة المفتوحة على التنوّع والاختلاف، بل، مثل ما يحدث اليوم، على نزاعات وصراعات باتت تهدّد العالم كله، ولن تكون عزلات المثقف، في أجوائها المضطربة، إلا عوامل مساعدة على مضاعفة اتساعها، وزيادة أضرارها على يد هؤلاء المتسّلطين على الشعوب .وهذا لا يعني أن هنالك حلولاً سحرية يقدّمها المثقف للخلاص، ولكن عليه كشف حقيقة ما يحدث، وتفكيك عناصره الملتبسة التي تداخلت في شبكة معقدة من المصالح والدسائس، وأخطرها ما يجري الآن من توظيفٍ للدين ورموزه، التي تهيمن على عقول الكثيرين، لخدمة مسميات زائفة كـ”الجهاد” وتأسيس “دولة إسلامية” أو ما تقابلها وتتداخل معها من سياسات ومواقف باتت أداة قذرة لوحش المال المتغوّل، ولأمراء وتجار الحروب، وهم جميعاً في تضادهم المتواطئ، يرسمون اليوم خطوط خارطة الدم القادمة لمجتمعنا البشري على إيقاع ” توازن الرعب “الذي يُنعش اقتصادات التسليح، ويفتح مخازنها على أسواقٍ ومساحاتٍ أوسع.
هل سيكون لما يكشفه المثقف، اليوم، دورٌ فاعل في تجذير وعيّ جديد له ولاداته المؤثرة على تغيير مسار الأحداث في العقود القادمة؟ أقول، ولكي لا أُتهم بيوتوبيا التفاؤل الساذج: أكد لنا من علمّونا على أن ننذر أنفسنا للحلم الإنساني، وأن نحمل وردة الأمل في مواقد الرماد، بأن النبتة الصغيرة تخرج من صلابة الحجر بغريزة الحياة .. فهل هم على صوابٍ حينما يتعلّق الأمر بحياة الإنسان كما نعرفه الآن، وما سيكون عليه غداً؟ ومن هو الذي سيُنبت ورداً للحياة في أتون الحروب القادمة؟ وعلى من تؤشر أصابعنا اليوم ليكون مثالاً بديلاً لمفترسي حياتنا؟.. نحتاج إلى الأسئلة، قبل اليقين، لنفكّر أفضل.