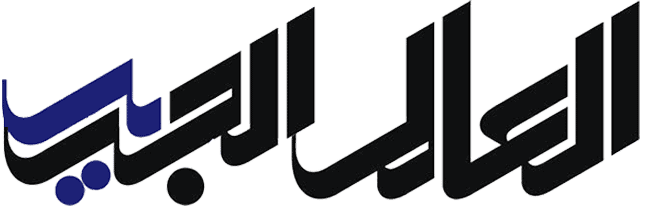أشعر بخيبة أمل تجاه قرارات الحكومة الاتحادية بالاستجابة البطيئة والتشبث بالسلطة بعد سقوط نحو ١٦٠٠٠ عراقي بين شهيد وجريح ومعاق، لكن لست مؤيدا للحل العسكري من طرفي المعادلة؛ المطالبين السلميين المظلومين، والسلطة التي ينبغي عليها ان تستجيب بسرعة، وأنه لا يوجد مبرر للانقلاب العسكري، ومن المهم إجراء انتخابات بقانون جديد ومفوضية جديدة لها مصداقية يشارك فيها الجميع، رغم أن الديمقراطية في العراق عمرها قصير لا يتجاوز ١٦ عاما، إلا أنها كانت مشوهة جدا أفقدت الناس الثقة بالوسائل الديمقراطية، حتى اصبح بعض العراقيين يفكر بصعوبة نجاح الديمقراطية دون تدخل من الجيش لتعديل التوازنات والمواقف، إذ ألفت مواليد ١٩٤٠-١٩٧٠هذا التدخل العسكري بدعوى الحفاظ على الأمن والسلم الوطني، دون الالتفات الى أن الحكم الديكتاتوري والعسكري لا يفترقان، ومن الصعب عندئذ رسم حدود فاصلة وواضحة بالعلاقات المدنية العسكرية، وإرساء ثقافة ديمقراطية لديها القدرة على التطور والنمو السليم، تتجاوز التقاليد العسكرية بما تحمله من معوقات أمام هذا التطور الديمقراطي.
وبالرغم من مرور نحو 55 يوما على الانفجار الشعبي، فإنه يصعب تسمية ما يحدث “بالانقلاب “، وأنه لابد من إجراء المزيد من الأوراق البحثية لدراسة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتطورة منذ عام ٢٠٠٣، ومحاولة التنبؤ بما يمكن أن تتمخض عنه هذه الأوضاع في المستقبل، بالقياس مع التظاهرات السابقة في العراق.
ويعتبر الانفجار الشعبي إفرازا لواقع اجتماعي، وهذا الواقع يختلف من محافظة إلى أخرى، لذلك لا يمكن الجزم بأسباب محددة بعينها تتوفر في كل التظاهرات الغاضبة، لأن كل تظاهرة هي وليدة سياق معين لذا تتعدد الأسباب بتعدد الظروف مع اتحادها في المطالب على المستوى الوطني “تغيير سلوك النظام”.
ويعتبر هذا الغليان الشعبي نتاجا لتوافق مجموعة من المبادرات في العالم الافتراضي، عبر منصات الواتساب والفيسبوك وتويتر والتليغرام والانستغرام واليوتيوب، مع احتجاجات الشارع البغدادي وعلى رأسها مناطق الرصافة وساحة التحرير. ففي الفترة الممتدة من تشرين الأول ولغاية اليوم، تفاعلت تلك المنصات بكيفية عفوية مع أشكال التعبئة الاحتجاجية العامة.
فالاحتقان والسخط الملتهب والظلم الاجتماعي الناتج عن استئثار القلة باقتصاد البلاد، ونظام الحكم المتحزب الذي يؤدي إلى الكبت والقهر، كل ذلك خلق جوا غاضبا، جعل الشعب يعيش حالة من الخوف الدائم والانفجار بوجه هذا الواقع المؤلم.
هذا ما أثبتته التظاهرات الغاضبة المتنامية في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب ككرة الثلج بسبب الظلم الواقع على أهالها، وسنوات القهر المتوالية، إضافة إلى فشل تمكين مشروع الدولة الوطنية المرتكزة على المواطنة، وبسبب سيطرة أحزاب سياسية على مقدرات الحكم والتشريع والاقتصاد والامن، مما صدمها بموجات من التظاهرات الغاضبة، قواعدها جماهير الفقراء، زاده عدم الوفاء بالوعود والقمع المعتمد على الأجهزة الأمنية، ومما زاد سخط سكان العاصمة بغداد ومحافظات الـ٩ الأخرى، هذه المحافظات تعاني من رباعية القمع :القمع السياسي ، القمع الإعلامي، القمع الاقتصادي، وقمع الحريات العامة.
هناك عدة عوامل تحدد قيام الانفجار الشعبي في تلك المحافظات حصرا:
– المشاركة الفاعلة لمعظم شرائح المجتمعية في تلك المحافظات عدا المنتفعين حزبيا وسياسيا، تمثل المشاركة السياسية الفاعلة لجماهير الأحزاب السياسية الشيعية أهم مصادر الشرعية للنظام السياسي القائم بالرغم من نسب المقاطعة العالية لانتخابات ٢٠١٨، فالناخب من تلك المحافظات هو جاء بالأحزاب الحاكمة المسيطرة في البرلمان والحكومة، وبالتالي ألزمت جماهير تلك المحافظات نفسها تعديل المسار المعوج والتظاهر عليهم.
– تقاسم الأحزاب المحلية ثروات وسلطات تلك المحافظات وبقلة حزبية متهمة بالفساد ومجموعات حزبية تحكم المحافظات لصالح نفسها وليس لصالح سكان تلك المحافظات، اضافة الى ذلك أن تلك القلة ورغم اعتمادها الريف والعشيرة فان إدارات الحكومات المحلية قد قامت بشكل أساسي على علاقات القرابة والنسب والحزبية.
– غياب المشاريع الاقتصادية والعمرانية والحضارية، تتحدث الأحزاب السياسية في تلك المحافظات عن الإصلاح والانجاز، لكن تلك الإنجازات الفاشلة في أحسن الأحوال تشبه زراعة شوك العاقول التي لا تنفع كثيرا، فعلى سبيل المثال، شهدت الحكومات المحلية لتلك المحافظات مثل البصرة وذي قار وبابل في نهاية ٢٠١٨ البدء في تنفيذ إصلاحات اقتصادية وعمرانية وخدمية رغم انها دون الطموح لكنها سرعان ما تراجعت وتلكأت كليا عن تلك الإصلاحات مع نهاية السنة المالية.
– انعدام الثقة بالحكومات المحلية والأحزاب التي تدعمها وفقدان الأمل في التغيير، فكان الانفجار الشعبي ومادته الفقراء والعاطلين عن العمل وسوء الخدمات الصحية والتعليمية والبلدية وقمع الحريات وتسلط السلاح السائب.
ويكاد يخلص المتأمل في تاريخ العراق الحديث، منذ استقلاله عام ١٩٣٢، لنتيجة غير مشجعة تجاه تمكين الديمقراطية وادواتها، إذ يجد أن العراق لم يعش واقعا فترة ديمقراطية، وحتى محاولة التمهيد للممارسة الديمقراطية ليست لها سمة الديمومة، حيث تقطعها دوما انقلابات عسكرية، ما ولد ظاهرة صراع التيارات المدنية والوطنية والقومية والإسلامية مع الحكم العسكري، في حلقات متصلة من تناوب الحكم العسكري بعد عام ١٩٥٨ لم تكسر حدتها أو تعالج إشكالياتها بعد، ما أشاع عدم استقرار سياسي قادر لبناء وترسيخ قيم وثقافة ديمقراطية تكون عاكسة لمختلف شرائح المجتمع ومعبرة عنها.
ما يزيد من تلك الوضعية المتأزمة أن التأسيس الحديث للديمقراطية أتى عقب انقلاب عسكري أنهى حقبة ٣٧ عاما من الحكم الملكي، وليس عبر نظال سياسي حزبي مدني، ما جعل للمؤسسة العسكرية خصوصية فريدة داخل النظام في العراق، مع محاولة فاشلة لصدام حسين الذي حاول تطويع العسكر بعثيا لكن الحالة انعكست فصار البعث عسكريا.
فانقلاب ١٩٦٨، الذي استولى بموجبه العسكر على السلطة، وأنهي فترة الحكم العسكري “العارفي”، رفع عدد الانقلابات العسكرية إلى ٣ انقلابات. وأن كل الانقلابات السابقة كان لديها إصرار على الحفاظ على الحكم العسكري للعراق، وشكلت تحديا مؤسسيا خطيرا للديمقراطية والحريات العامة، فقد عبرت عن نفسها في أولى قرارات الرئيس عبد الكريم قاسم، حيث اعتمد المحاكم والقضاء العسكري. ما يثير تساؤلات حول ارتباط تفكير بعض من مواليد ١٩٤٠-١٩٧٠ بالخلاص من الازمات الكبيرة بطريقة الانقلابات العسكرية، من حيث التشجيع والاحتضان العسكري وفرض حلول عنيفة قاهرة لإزاحة الطبقة الفاسدة الحاكمة.
البيئة السياسية التي دعت هذه الأجيال لاقتراح حل الانقلاب العسكري سواء ان كان ابيضا او دمويا فقد كشفت تظاهرات تشرين السلمية دعوات العديد من ابناء تلك الأجيال لتغيير النظام السياسي بالعنف، وأن البعض من دعاة العنف (الحل العسكري) في العراق لم تتعاف بعد من ظاهرة الانقلابات العسكرية. إذ مازالت أقلام وعبارات بعض رجالات تلك المواليد لا تؤمن بالديمقراطية ولا بوسائلها التي جاءت أمريكا بها للعراق بعد عام ٢٠٠٣، فعندهم لابد أولا من إزاحة السلطة الحاكمة عن طريق الانقلاب واحالتهم للمحاكم العسكرية ثم تعديل او كتابة الدستور، فهذه دعوة دموية نحو تصفير النظام السياسي بعد عام ٢٠٠٣، وإعلان بداية جديدة، بداية تكافح من أجل إثبات الجدارة والحضور العسكري في مشهد سياسي لا تهيمن عليه الميول الوطنية الديمقراطية سواء تلك النابعة من ثقافة تقليدية راسخة، أو نخب سياسية بلغت مستوى الرشادة السياسية ودورها في ترسيخ القيم الديمقراطية داخل مجتمعاتها، عبر اللجوء المستمر للانقلابات العسكرية ووسائلها العنيفة لحسم الازمات التي تظهر في البلد.
وواحدة من الاحتمالات المطروحة للدراسة كحل لازمة الداخل العراقي هو تنظيم داخلي يقوم بانقلاب عسكري وإعلان حكومة مؤقتة لحين اكتمال الاستعدادات لانتخابات مبكرة على طريقة النموذج السوداني. هذا الاحتمال ان حدث سيكون هو الأكثر دموية، وتداعياته عميقة على العلاقة بين جماهير التظاهرات السلمية وجماهير أحزاب السلطة الحالية، والتنظيم الانقلابي، خاصة مع إلقاء الضوء على هشاشة الوضع السياسي والأمني الذي تعانيه بغداد، والذي يضاف إلى الأزمة السياسية الداخلية، والتحدي الأمني النابع من نمو شبكات تنظيم داعش.
تداعيات محتملة بطبيعة الحال، فإن الانقلاب العسكري سوف تكون له تداعيات بعيدة الأثر، خاصة على النظام السياسي العراقي وأنظمة الدول المحيطة بالعراق، وهو ما يمكن تفصيله على النحو التالي:
– ستعمل قيادة الانقلاب العسكري على إحكام سيطرتها على الحكم وإقصاء تنسيقيات وقيادات الأحزاب الحالية وكذلك اعيان وقيادات تظاهرات تشرين، ومن المفترض انها ستقوم باعتقال وتصفية المنافسين والخصوم وذلك بإعلان حالة الطوارئ والاحكام العرفية العسكرية، فضلا عن تعطيل القضاء والدستور وربما اجبار العشرات من القضاة وممثلي الادعاء على الاستقالة او الهجرة او الإقامة الجبرية.
– انتهازهم ذريعة القضاء على الفاسدين لإعلان ضوابط مالية ومصرفية معرقلة لنشاطات الاقتصاد العراقي، وتاليا تشهد البلاد أزمة اقتصادية وسياسية واجتماعية داخلية تمس شرعية الانقلاب المحتمل، الامر الذي يفرض على قادة الانقلاب تقديم التنازلات التي قدمها ساسة النظام الحالي لأمريكا وإيران والخليج وتركيا، والتي تتناقض مع شعارات تظاهرات تشرين. فضلا عن عجز قادة الانقلاب عن حماية التظاهرات من تمرد وانتقام القيادات المناصرة لهم.
– سوف يؤدي الحل الانقلابي الى اهتزاز النظرة التاريخية للقوات المسلحة العراقية وخاصة الجيش الذي ينبغي ان يكون في خدمة الوطن كما ان الشرطة في خدمة الشعب، ويحد من فرص بقاء القوات المسلحة العراقية مستقبلا في الحياة السياسية والمجتمعية.
– انهيار ما بقي من البنية المؤسساتية والخدمية والاقتصادية على طول فترة حكم الانقلابين.
– ومن شأن الانقلاب العسكري أن يلقي بظلال من الشك حول الاستقرار السياسي في العراق خلال الفترة المقبلة، خاصة في ضوء استمرار النزاع على مناطق المكونات والثقافات المتعددة بين بغداد وكردستان، الامر قد يدفع بالعسكر الى تبني قرارات حربية تهدف إلى تعزيز سلطاته في مواجهة النزاع على هذا الملف.