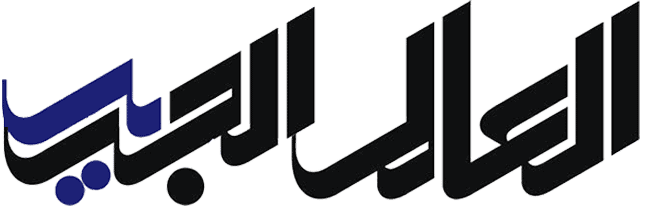“هل خيامكم بخير؟” سألني أستاذ الرياضيات، فهززت رأسي إيجابا، “خيمتنا بخير، الريح اقتلعت خيمتين في قاطعنا، لكن خيمتنا بخير”، وقام بتوزيع الأسئلة لإجراء امتحان نصف السنة.
وقد اعتدنا على أسئلة كهذه، فلم نعد نكترث بما يشعر أحدنا، ولا الصحة النفسية والعقلية، بل نصوّب جلّ اهتمامنا نحو الخيام، هل اقتلعتها الريح؟ هل أحرقتها النار؟ هل أثقبتها شمس الصيف الحارقة؟
“فؤاد، لاحظتُ تراجع مستواك في الفيزياء، هل هناك مشكلة؟” سألني مدرس آخر، فرفعتُ عينيّ نحوه، وأجبت: “لا أستاذ، كانت هناك مشاكل فلم أستطع الدراسة، كما تعرف 8 أشخاص في خيمة واحدة”. لاحظت نظرة تعاونٍ في عينه، “أنا وزوجتي نسكن خيمة وحدنا، يمكن أن تدرس معنا، هي أيضًا تدرس في كلية اللغات قسم اللغة الإنكليزية، ويمكن أن تساعدك في الإنكليزية، فهي نسخة مصغرة عن سيلفيا بلاث التي لا تتوقف عن إلقاء قصائدها”.
وحين أتذكر الآن، قراءتي للفيزياء النووية ومبدأ اللادقة لهايزنبرغ، والنظرية الموجية للضوء، والنسبية لأينشتاين، في خيمة مع زوجٍ بالغٍ تفوح منهما رائحة الأمل والبراءة، وتعفن القلوب المعطلة، يريدان إنجاز شيء ولو بسيط، كما كان يتأمل أبي أن أفعل، أن أصبح مهندسًا. أو كما أرادت أمي أن أصبح طبيبًا. لكنني أردت أن أصبح شاهِدًا على حياة هؤلاء. لم أكن مليئًا بالأمل والتفاؤل نحو المستقبل كما أذكر في مقابلاتي مع جهات العمل، بل كنتُ أبحث عن طريقة لسرد ما يحدث هناك في أقفاص الحيوانات البشرية التي وضعونا فيها، لأننا ولدنا في مكانٍ كهذا، وبهوية كهذه، وقد قتل البرد في الشتاء مئات الآلاف من الكلمات في رأسي لعجزي عن الخروج من تحت الأغطية، فأطرافي كانت ترتعش بردًا والبرد سيّد العالم. ما زلتُ حين أتصل على أهلي، وأتحدث مع أمي، اسألها السؤال الوجودي الذي نسيه الفلاسفة: “هل خيمتكم بخير؟”. فتجيبني بصوتٍ أقرب للصرخة فيما تدلق السماء دموع آلهتها على الخيام: “خيمتنا بخير، متى ستعود إلى المخيم؟” تسألني منهمكة بالبحث في الأرجاء. “أنا؟ قريبًا، سأعود قريبًا”. فتنهي الأتصال وتهرع لوضع دلة لاحتواء مياه المطر المتسربة من الثقوب في النايلون الذي أوصلنا به الخيمة مع المطبخ والحمام.
في مدرسة المخيم، حيث درست ويدرس الآن أخي، واخواتي، هناك كرفانات، وسياج حديدي حول المدرسة، لتشبيهها بمؤسسة تعليمية قدر الإمكان. أكثر من ثلاثين طالبًا في كل صف، وأكثر من دوامٍ واحد في كل مدرسة. المدرسون الذين يتكفلون بتعليم الطلبة، أغلبهم غير متخصصين بالمادة التي يدرّسونها، وبعضهم تخرّج من معهد المحاسبة فيدرّس مادة علمية كالأحياء أو الفيزياء، ولا سؤال إذا كان مطلعًا على أسس التدريس وعارفًا بتطور العالم وطرق التدريس والصحة النفسية للطلبة، ربما يسألهم في امتحان الرياضيات عمّا إذا كانت خيامهم بخير.
أغلب هؤلاء المدرسين، أو كما تمت تسميتهم بالمحاضرين المتطوعين، أو المجانيين، كانوا يقضون ساعات في تعليم الطلبة دون مردود مادي، وفيما بعد، طلبوا من الطلبة جمع راتب بسيط لهم، يصل لـ150 ألف دينار عراقي شهريًا، لإعالة أهلهم، ولصرفها على الخيم التي تقتلعها الريح، أو تحترق.
على الرغم من أن العراق هو الأول عالميًا برواتب الحكومة، إلا أن القطاع التعليمي يعاني من نقص في الكوادر التدريسية يصل إلى ما يقارب 90 ألف موظف. بالتزامن مع ارتفاع نسبة التسرب من المدرسة تصل إلى 35% في المرحلة الابتدائية، و45% في المرحلة الثانوية.
كما يعاني الطلبة من نقص كبير في كتب المناهج التدريسية، فيضطر الطلبة إلى استنساخ الكتب، ما يثقل على كاهل العائلات النازحة المنهمكة بالنجاة من الجوع الذي يتربص بهم. أو استعارتها من طلبة سبق وأن تخرجوا من المدرسة، في الصف السادس الإعدادي، المرحلة المصيرية التي تحدد تخصص الطالب، واحتمال حصوله على عمل، في ظل تفشي البطالة.
هذا والظروف المؤسفة التي يعاني منها الطلبة اثناء المحاضرات، فأذكر أننا جمعنا النقود لشراء وسائل للتدفئة شتاءً، لتحمل برودة الجو الذي وصلت درجة حرارته إلى تحت 5 سيليزية. بعض الطلبة يتكفلون بإحضار جزء من حصة عائلاتهم من النفط الأبيض للمدافئ. كمحاولةٍ للتأقلم مع الوضع في مخيم بين سلسلة جبال.
مَن سهر الليالي..
سيطرة الميليشيات على مناطق عدة، تمنع إنشاء مشاريع تجارية، وبالتالي بطالة مؤكدة للبالغين الباحثين عن العمل لإعالة أهلهم. الوضع الذي يدفع برب الأسرة إلى التفكير بلقمة تسد جوع أهله أكثر من تفكيره بالموت والحياة. كما أن قضاء عقدٍ من الزمن في مخيم للنازحين يُضعِف مُحاولة إقناع الأطفال بالمستقبل المشرق وضرورة السعي لنيل الأفضل، فنظرة واحدة على سوق العمل في البلد، تكفي لفهم كيفية القبول في العمل. أغلب المناصب والوظائف يشغلها معارف وأعضاء أحزاب سياسية، وفق نظام المحاصصة. أنّى لمواطن مجتهدٍ صاحب شهادة أن يعمل في تخصصه لإعالة أهله؟ أنّى لنازحٍ في مخيمٍ على تخوم الجبال أن يعيش بطريقةٍ يحفظ فيها كرامته ولا يشحذ لقمة عيشه في طوابير توزيع المواد الغذائية؟ فالطوابير أيضًا والمساعدات توقفت بعد انسحاب المنظمات الإنسانية.
ما يثقل على كاهل الطلبة وأهاليهم في المخيمات، هو غياب الخصوصية للتركيز أكثر، إذ أن كتب المناهج الدراسية المقررة من وزارة التربية العراقية تحوي موضوعاتٍ تصعب على المدرسين غير المتخصصين أنفسهم، فكيف بالطلبة؟ الذين يدرسون في خيمة يشاركونها مع عائلاتهم، أغلبها تتكون من أكثر من 5 أشخاص، بأستحالة الخروج من الخيمة والدراسة شتاءً. فيطلبون من أهاليهم أن يصمتوا كي يحل مبرهنة فيثاغورس، أو أن يرسم الخلية بدائية النواة، أو أن يركز في فهم النظرية الموجية للضوء.
بطالة وخريجون بالمئات..
ما يُصعب عملية تشجيع الطلبة الصغار على الدراسة وسهر الليالي لنيل الشهادة وسد ثغرة في المجتمع، هو حضور المئات من حاملي الشهادة العاطلين عن العمل، فلا أندهش من رؤية رجلٍ يبيع الخضراوات تخرّج من قسمٍ دراسي أدرسه، ومتخرج من كلية الآداب قسم التاريخ يبيع المواد الغذائية في المخيم لإعالة أهله، وسط تكتم حكومي وإهمال للمشاريع التجارية الخاصة، التي ستفتح الباب أمام الباحثين عن العمل للعثور على فرصٍ جديدة. فتقديرات تشير إلى وجود فائض في أعداد الأطباء والصيادلة في العراق، يزيد عن قدرة الدولة على التوظيف، ما سينتج بطالة مؤكدة في 2030، حتّى في الجانب الطبي، الأكثر شهرة وسعيًا من قِبل الطلبة في العراق. فبرغم الظروف المأساوية التي يعانيها الطلبة والأهل خلال عملية تخريج الطلبة، ينصدم الطالب بسوق العمل الذي لا يقبل متقدمًا إلا بتوصية من كبار المسؤولين والمتنفذين.
مَكيجة الوضع وتكميم الأفواه..
فيما تطالب السلطات بالتركيز على الجانب الإيجابي للبلد، وعدم تشويه صورته في المجتمع الدولة، كمحاولة لمكيجة الوضع وتجميل البنية الاجتماعية بإزالة الأطراف القبيحة المنتقدة، التي لا تقدر سهر الحكومة ليلاً ونهارًا على خدمتنا. ومن جانبٍ آخر، يحق لهم التذمر من شكوانا، ففي نهاية المطاف، علينا أن نكون ممتنين لأننا لم نمت بعبوة ناسفة، أو قنبلة عشوائية تسقط على البيت، أو بحريقٍ يلتهم الخيمة، أو بحربٍ التهمت مئات الآلاف من العراقيين بسبب عجز المؤسسات الحكومة عن التصدي للإرهاب. تقرير لمركز الخليج لحقوق الإنسان بيّن وجود انتهاكات لصحفيين ومتظاهرين ومتظاهرات في مناطق مختلفة من العراق، وأدان القوة المفرطة المستخدة لفك تظاهرات مهندسين ومهندسات مطالبين بفرص عمل كأي إنسان طبيعي. كيف يمكن تفسير ظاهرة تعنيف المجاميع المطالبة بأبسط الحقوق الإنسانية، سوى كونها مظهر من مظاهر الديكتاتورية المخفية. فأين الديمقراطية التي تتغنى بها السلطات بعد 2003، والحرية واحترام حقوق الإنسان، وما تلاه من كلام مرتب؟
الحرية قفص لعصافير العراق
إن التابوهات في العراق تتجاوز حدود المعتاد عليه، فأي فعلٍ يُمكن أن يُصاغ كأنتهاك للقدسية بمختلف وجهات النظر إذا كان يؤثر على مصالح جهةٍ ما أو شخصية ما، ولإن كان التقديس محصورًا بالدين، فقد تغيّرت وجوهه، وصار أكثر شمولاً وأوسع قاعِدةً، فتخضع لقانون القدسية المناطق ورجال الدين والساسة وعائلاتهم والديكتاتوريات الصغيرة والكبيرة، ورغم المحاولات العديدة لقنين حرية التعبير بما يتناسب مع مزاج السلطة، ما زال هناك موضع لكلمة أخيرة، عليها أن تُحرِقَ لسان قائلها كجمرةٍ مشتعلة، وأذان سامعيها لتُغرس في أعمق منطقة من عقولهم، وهي بسيطة بقدر ما هي إنفجارية، يخافها رجالات السلطة ويُرددها شبان عراقيون: إن كان العالم كله مقدس، فبأي حقٍ يُهدر دمُ العِراقي، ولا يُعتبر مقدسًا؟ نُريد وطنًا!
أية يدٍ إلهية ستطرد شبح الموت عن العِراق، كي يحيا المواطنُ ويتغنّى بصوته، ولا تُقطع ألسنة الناطقين، المطالبين بحق العيش؟ أية سماءٍ هذه التي ملأتها أسراب أرواحنا، ولا تسقط من ثُقل أفئدة العِراقيين المجروحة مُنذ أبد الآبدين؟ على هذه الأرض، موتى الحرية وساحاتها، وعصافير ترديها مقتولة بنادِق هواة الصيد في مزارعهم الخاصة.
بحسب تقرير لـ”هيومان رايتس ووتش”، هناك انتهاكات محزنة لحقوق الإنسان وحرية التعبير في العراق، وقوانين العقوبات المتعلقة بالأمر غير معرّفة كفاية.
ماذا سيكون مصير هؤلاء الطلبة بعد التخرّج إذا نظموا تظاهرات وطالبوا بحقوقهم، هل سيحرقون خيامهم لفض التظاهرات، أم سيأخذونهم للسجون، غير أن السجون أكثر أمانًا من الخيام، فهي لا تتأثر بالأمطار والعواصف والحرائق. أم أنَّهم سيعودوا “طواعية” إلى مدنهم تاركين المخيمات، لنبذ مفردتي “التشرد” و”النزوح” من قاموس البلد. لتحل محلها مفردة “ميت”، فمناطقهم، وبعد سنوات من انتهاء الحرب المزعوم، ما تزال تفتقر لأبسط المقومات اللازمة للعيش، كفرص العمل والمدارس المؤهلة والبيوت المعمرة والشوارع المبلطة. والأهم: عودة الجو الأجتماعي للمشهد، والمشاركة الفاعلة في بنائه، إلا أن ذلك لا يتم إلا بإعادة المفقودين\ات، والكشف عن المقابر الجماعية.
السماء حقيبة دراسية في مخيمات النازحين
سر في شارعٍ من أكثر من 20 مخيمًا في مناطق مختلفة من كردستان، أو جبل سنجار، سترى جموعًا بشرية صغيرة، تتجه نحو مدارسٍ يربض أبولو فوقها كحارسٍ يحمل نور العلم وقلم يغرسه في صدور الجهلة. على ظهورهم حقائب لها لون السماء وزَّعتها يونيسف، كلها متشابهة، سماوات على ظهورهم، لأنَّ السماء الفعلية، بيت الآلهة، محجوزة لرجالات الحرب، ولا مكان لهم فيها. إذًا، وكطريقة البدائيين في صنع اسطورة لتحمّل العالم، نصنع في مخيماتنا اسطورة أننا عراقيين، لتحمّل ثقل مفردات كالتشرد، والضياع، والنبذ التي قامت بها حكومات متعاقبة بحق هؤلاء الناس. حكومات سعت لمعاقبة النظام السابق الفاسد، دون إنهاء الفساد والدمار الذي خلَّفه.
أطفال ولدوا في المخيم، وسُجِلوا في مدارس المخيم، وعرفوا أن بيتهم هو الخيمة رقم 14 في قاطع 17 L، أو في الكمبة الأولى وليس الثانية في مخيم بيرسفي، أو الخيمة المُضافة بشكل عشوائي على شارعٍ من الخيم لأن خيامها كلها محجوزة.
أطفال ولدوا وكبُروا وشاخوا بين أرض المخيم وسماءٍ مثقلة بدموع أمهاتهم على المفقودين في المقابر الجماعية في سنجار، أطفال حين تسأل أحدًا منهم: من أين أنت؟ سيقول لك: القاطع رقم…. لأن وطنهم أطفال في خيمات النازحين يحملون السماء على ظهورهم، وأسلحتهم، ليست الأقلام كما قالوا، بل خلو خزائن ذاكراتهم من الحياة. كيف ستقتل شعبًا ميتًا؟ كيف ستوقف عجلة سيره نحو المستقبل، إذا كانت ثروته بطاقة “نازح” وخيمة أتعبتها تقلبات الجو؟ كيف ستحذف كلمته إذا كانت مكتوبة بدمِ رجال سنجار؟ ودم عذرية نساء سنجار اللواتي اغتصبهن أعضاء تنظيم داعش وباعهن في أسواق النخاسة؟
هناك كلمة أخيرة سيكتبها هؤلاء الطلبة في مخيمات النازحين، وستُعلّق على جدران المنازل التي نجت من التدمير في سنجار: سنبقى ما أن بقيت البشرية، وسنبقى حتّى بعدها، لأن الموت الذي تستوردونه من الخارج لا يشملنا، لنا موتنا، نختبره كل يوم في طوابير التشرد، ولن ننتهي حتّى نهاية العالم.