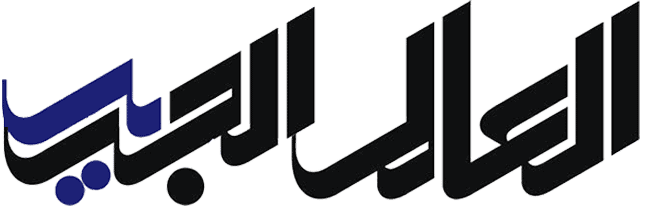حاتم كناعنة
بعكس مؤلف كتاب “المتفائل” لتامر سوريك الذي لم يقابل القائد الفلسطيني توفيق زياد وسمع به من المنشورات الصهيونية العبرية بشكل أساسي، كنت أعرفه وأكن له بالغ الاحترام منذ أيام النكبة. في تلك اللحظة – المنعطف كان تقريبا يبلغ ضعف سنوات عمري، فقد كنت في الحادية عشرة، وكان موهوبا وواعدا، وفي ذهنه بوادر ثورية، وكان مقداما، يؤمن بروح فلسطين ومبادئ الحزب الشيوعي. وله صوت رنان يدعمه في كل كلماته وخطاباته. وكان هذا النجم الصاعد قريبا مني ومن أبناء جيلي. ولم يكن من السهل تجاهل صوته الثاقب ولا سيما إذا ألقى كلامه بمكبرات الصوت التي دخلت الخدمة حديثا. في عام 1954 ورغم القبضة الحديدية لحكومة العسكر التي فرضتها إسرائيل على الفلسطينيين، قاد توفيق كناعنة زميلي في الصف الثامن في عرابة، وهي قرية تتبع الجليل، وهو أيضا ابن عمي وشيوعي، إضرابا ناجحا وموفقا للاحتجاج على ضريبة الأفراد التي منينا بها وحدنا، وليس بقية المواطنين اليهود. ورغم الضغط الذي طبقته الحكومات العسكرية على الأهالي، انتشر الإضراب إلى بقية المدارس، وأدى إلى إلغاء الضريبة العنصرية. والآن وأنا أتذكر مع ابن عمي توفيق ما جرى ذكر لي إضرابا آخر حالفه النجاح، لكن نسيته تماما، ربما لأنه كان محدودا وضمن قطاع الفلاحين المحليين في الجليل. بالعادة في بواكير الشتاء يبحث كل من ليس لديه أرض عن عمل في حصاد الزيتون في القرى المجاورة. وبعد النكبة وسياسة التطهير العرقي التي حولت 500 عائلة فلسطينية إلى لاجئين يعيشون في الخيام في البلاد العربية، وقعت القوات الإسرائيلية الرسمية العقود مع بعض الزعماء المحليين أو مع المتعاونين معها. ومنحتهم إمكانية العناية بالأراضي المهجورة وهي بساتين زيتون. وبعكس الإجراء المتبع، وهو الدفع يوميا لكل عامل حسب كمية القطاف، بدأ المتعاقدون يماطلون بالدفع حتى نهاية الموسم، ويخفضون الأجور. ولذلك فجر الشيوعيون في عرابة، ومن ضمنهم ابن عمي، إضرابا ناجحا. لكن مات هذا النجاح الملحوظ في الذاكرة العامة. ودون أي شك كان توفيق زياد وراء هذا النشاط. احتفلت عرابة بانتصارها في قضية ضريبة الأفراد، وحشدت لاجتماع عام ألقى فيه توفيق زياد، النجم الشيوعي والوطني الصاعد، كلمة على المجتمعين حتى سحرهم بصوته.
وقد كتب عن ذلك الصحافي الاسرائيلي ي. كيناروت. وأشار لبروز شخصية أبي الأمين (بمعنى الشخص الموثوق. وهو الاسم الحركي الذي أطلقه عليه معاصروه وأصدقاؤه). ويومها تمت ولادة سياسي أصبح أيضا شاعر حركة المقاومة. نشر معاريف عدد حزيران 1957 المقال، تحت عنوان هزلي هو “ناصر لم يحضر ليشد من أزر توفيق زياد”. ومما ورد فيه:
“متجاهلين قرارات الحكومة العسكرية التي تمنع الدخول لمناطق مغلقة <أقرأها: تمنع كل السكان العرب في إسرائيل> دون إذن من السلطات الأمنية <أقرأها: ممثلي الحكومة العسكرية التي ترفض منح الإذن بالعادة> كان زياد يقفز بحرية <أقرأها: يدخل بالسر وغالبا من طرق زراعية خلفية> من قرية عربية إلى أخرى، ليجمع الفلاحين في ساحة القرية، ويلقي عليهم كلمة نارية مليئة بالحقد <أقرأها: إدانة نارية لضريبة الفرد العنصرية> ويستهدف بها الحكومة، والسلطات، والنظام العسكري، إلى أن نصب له الأمن كمينا. ففي عام 1955 تم اعتقاله في عرابة، القرية العربية الشريرة <أقرأها: القرية الفلسطينية النموذجية التي أقدمت بشجاعة على الاعتراض>. وهي في الجليل الأوسط. وحملوه وهو في منتصف كلمته إلى سيارة السجن وقادوه إلى أقرب مخفر”. / انتهى الاقتباس.
يروي كتاب تامر سوريك، وهو مؤلف “المتفائل: سيرة اجتماعية لتوفيق زياد” منشورات جامعة ستانفورد، طبعة كيندل، 2020، أن زيارة زياد الشهيرة إلى العرابة جرت يوم 24 نيسان عام 1954، وذلك للاحتفال بإطلاق سراح أربع نشطاء سياسيين. وفيها دعا لثورة ضد الضريبة، ولإضراب طلابي، فاعتقل وفرضت عليه الإقامة الجبرية في المنزل، من الغروب وحتى الفجر. ومنع من مغادرة الناصرة لست شهور. ومنذ ذلك الاعتقال حتى دخوله إلى الكنيست عام 1974 رأى سوريك أن الحكومة العسكرية والشرطة حدوا من حرية حركته. ويتهم سوريك في مقدمته “المستشرقين” الإسرائيليين بالتعاون مع القوات الأمنية الإسرائيلية والعمل بخدمتها رسميا أو ما يشبه ذلك. ويستثني نفسه من هذه الشبهة ويقول: “لا توجد طريقة سهلة لتفادي هذه العقدة، ولذلك أحذر القراء أن هذا الكتاب لا يسعه التظاهر أنه أكثر مما هو عليه: صورة متفهمة لأيقونة سياسية وفلسطينية وثقافية يكتبها باحث يهودي إسرائيلي”.
ومع ذلك مهما بحثت لن تجد جوابا عن سؤال يحرق الصدور وهو أين يقف الكاتب من الصهيونية؟. وبالمثل لم أجد إجابة عند أي صديق من أصدقائه بعد أن اتصلت بهم لأستفسر عن موقفه العلني والرسمي. ولذلك ليس أمامي غير البحث في هويته “اليهودية والإسرائيلية”. وإذا أخذنا ذلك بعين الاعتبار سيكون من المهين للباحث أن تفترض أنه لم يسمع عن انحياز المطبوعات “اليهودية الإسرائيلية” التي تحمل رؤية جاهزة عن الفلسطينيين عموما، وعن قادتهم على وجه الخصوص. (ومن الأمثلة عن سوء التفاهم العبارات التي أضفتها داخل أقواس أعلاه). وبالنتيجة أصبح من الواضح لي: أن تامر سوريك يبخس من قدر توفيق زياد. لكنه لا يشكك بانحياز المصادر “الإسرائيلية اليهودية” التي عاد إليها. وينقل الغمزات الساخرة دون تعليق.
وهكذا نجد أنفسنا أمام السؤال التالي: ماذا يحرك الإعلام والكادر الرسمي “الإسرائيلي اليهودي”؟. وهذه بذرة كل الأسئلة. فاستمرار وجودنا المجرد كان ولا يزال غير مقبول ولا مفهوم برأي الإسرائيلي اليهودي العادي. والقضية هي ارتباط إنساني بأرض ولدنا عليها، وتحولت إلى جزء من هويتنا. وبنظر غالبية شركائنا الإسرائيليين إن المطالبة بحق المواطنة والمساواة والحرية الإنسانية مثل كرة الجليد. مع الزمن تكبر وتخلق مشكلة لإسرائيل.
في السبعينات بعد عودتي من أمريكا إلى عرابة، قريتي، كنت أول طبيب فيها، وكان صوت زاهي الخطيب رنانا حين يتكلم بمكبر الصوت، وكان هو حداد عرابة الشاب، ولسان حال الحزب الشيوعي المحلي، وقد ترك عند الجميع تأثيرا سعيدا وغامضا. الآن أعتقد أنني أعرف السبب الذي جعلني أهتف كلما سمعت خطاباته دون أن أفهم معناها في كثير من الأحيان: لا بد أنه مثل تأثير صوت أبي الأمين السحري. ففي عرابة أثارت قيادته لنا أكبر ضجة بسبب حادث الاعتقال البطولي. فقد استسلم لهم دون اعتراض أو جدل لا مبرر له. ولاحقاً بلغنا كيف عذبته الشرطة في مدينة طبريا. وسمعنا أنه تم تعليقه من ذراعيه وساقيه على إطار نافذة زنزانته، وتبع ذلك الضرب المبرح حتى فقد وعيه. وشبه لنا زياد تعذيبه بأنه “صلب”، على غرار ما فعلت سلطات الانتداب البريطاني مع المتمردين الفلسطينيين في انتفاضة 1936-1939. وكلما استيقظ كان يبصق في وجه معذبيه، فيزيدون الضرب حتى يفقد وعيه مرة أخرى. ولا أستغرب أن عائلته ذكرت أنه كان ينفر مدى الحياة من زيارة طبريا.
ولكن تفكير زياد العلماني لم يشجع التلميحات العابرة التي أتت من أصدقائه وقارنته بمواطنه الناصري، يسوع المسيح. غير أن سوريك يتابع كثيرا مع التشبيهات الدينية التي تساوي بين التزام زياد بالشيوعية وإيمان ودوغمائية المتدين المسلم. وأرى في ذلك تفسيرا بريئا لبطولة زياد الواقعية. ولكن أستطيع تصور اعتراض رفاق زياد: فهذا الكلام تهمة غير نظيفة. وتضعه في صف ألد أعدائه السياسيين، أعضاء الحركة الإسلامية. فأن يكون مسيحا يعني أنه يمارس عبادة عمياء، مع فرق واحد، أنه يؤمن بماركس وليس بالاله.
وتجد حكاية تنقل زياد بشكل لا قانوني من قرية لقرية في الجليل، في الفصل الثاني من الكتاب بعنوان “الثبات”. وهي صفة فيزيائية وخارقة وتدل على أخلاق سامية، وتصف بكلمة واحدة مخاض صراعنا الاجتماعي – نحن الفلسطينيين، من حمل هوية إسرائيلية ومن عاش بصفة لاجئ، أو من انتقل إلى الدياسبورا. إن كفاحنا اليومي ومعاناتنا، إن كنا أفرادا مثل أبي الأمين، أو مدينة كالناصرة وعرابة، جعلنا نحمل سلاح الضعفاء والأقليات المهملة في العالم. وهو سلاح الــ “صمود”. وكان لأبي الأمين موهبة تميزه من بين الجميع، سواء في السجن، والتجمعات الحاشدة، أو البرلمان الإسرائيلي. وبرأيي إن اسم أبي الأمين يكفي لتعزيز تفاؤلنا وبمبدأ مقاومة الظلم والدعوة للدفاع عن حقوقنا، فصموده كان وراء موهبته الأدبية الأسطورية ووراء إيمانه الراسخ بالنصر النهائي الذي ستحققه الطبقات العاملة، وخلف احتجاجه ضد الظلم وخلف موقفه الذي لا يلين ضد فاشية اليمين الإسرائيلي بزعامة راحباعام زئيفي. كان الصمود ولا يزال يعبر عن أملنا بمستقبل أفضل وعادل، وكان أبو الأمين رمزا حيا له.
تضم شخصية زياد “اليوتوبية” الشيوعية موهبة في الشعر، وإحساسا عاليا بالأخلاق، ومعرفة واسعة بجمهوره المحلي، وهو ما أهله ليكون “أول عمدة شيوعي لمدينة شرق أوسطية وعضوا طويل الأجل في الكنيست الإسرائيلي”. ولم يظهر عليه الخوف أو التردد، حتى وهو يتهكم من معارضيه لإسعاد مناصريه. ومع أنني لست شيوعيا متعمقا مثله أرى أنه وطني يدافع عن السلام بطريقة محببة.
بالعودة إلى الاقتباس السابق: وأنا أقرأ أول سيرة عنه وأول عمل عن بطل نحترمه جميعا وبلغة إنكليزية أكاديمية، اتصلت بعدد من الأشخاص الذين ورد ذكرهم وكانوا مصدرا للمعلومات. دون استثناء أثنوا جميعا على جهد الكاتب وإصراره. وفي مرحلة ما كان يقتبس من إفادات شفهية من حلفاء سابقين لزياد ولكن تخلوا عن الحزب. غير أن الكاتب لم يتصل بنصف دستة من الأحياء وأصحاب الذاكرة القوية الذين شاركوا بتنظيم حادث “عرابة، القرية الشرسة في الجليل الأوسط”. وأتساءل هل ثناه عن ذلك شراسة القرويين؟.
وحتى لو قبلنا أن تامر سوريك نأى بنفسه عن أساليب المستشرقين الإسرائيليين وخدماتهم إلى الشين بيت، لم يفحص الخطاب الخبيث الذي يسخر من كفاح زياد ضد الحكم العسكري العنصري، ولم يشكك بالإعلام الصهيوني الذي دفنه تحت “خطاب الكراهية” ودمر القرية المضيافة العرابة، قريتي. وبرأيي هذا الصمت هو تستر يشبه لغما أرضيا.
مجددا: بالنسبة لي الموضوع واضح وبسيط. الصهاينة استهدفوا مصادر روحنا الحية، وهي أرضنا الزراعية. ولربما لم ألاحظ الضرر المبطن لو رأيت بوضوح ميول الكاتب الصهيونية، ولا سيما مع استمرار الاحتلال لكل فلسطين منذ عام 1967.
مثال آخر على علاقة معلومات سوريك بالإعلام الإسرائيلي تجده في تبرئة دافيد بن غوريون من شبهة التطهير العرقي في الناصرة عام 1948. فقد نفى جون كوك ادعاءات البراءة هذه. ولكن برر سوريك قرار رئيس الوزراء على خلفيات أهمية الناصرة للمجتمع المسيحي في العالم. وفي طوايا هذه السردية حقيقة تؤكد أن بن غوريون أصدر قراره الشفهي لتفريغ كل المدينة من سكانها. وحينما طلب بن دانكيلمان القائد الكندي اليهودي زعيم قوة هاغانا، قرارا مكتوبا، قام بن غوريون بتأجيل قراره السابق. وعلى ما يبدو أنه بدأ بالتخطيط لاستراتيجية بديلة للسيطرة بالقوة على سكان وإدارة الناصرة. ففي عقد الخمسينات تابع جهده باستعمار الأراضي المصادرة وأراضي القرى الفلسطينية المجاورة لها في الناصرة العليا، والمعروفة حاليا باسمها الجديد نوف هاجليل.
وهذا مثال آخر عن عدم تحقق الكاتب من المصادر الإسرائيلية المشكوك بها: حتى أن سوريك يذكر دور زياد العابر في عمل جماعة من الناصرة جنوا البرتقال في يافا. ويشير إلى مشكلة بين العمال الضيوف واللاجئين الفلسطينيين الذين كانوا في يافا. ويعزو ذلك لتأثر رجال الناصرة بالكحول. وسيرى من يفكر بالحدث أن مصدر الإشاعة كان مكتب وزير الأقليات، وهو بنية موازية ومركزية للحكم العسكري الذي يهتم بقمعنا وسرقتنا، نحن المتبقين في إسرائيل. وتامر سوريك يعلم جيدا عدوانية هذه المصادر الإسرائيلية. ولكنه يقبلها على علاتها ويرى في الكراهية “صورة مسلية وبليغة لزياد”. من ذلك ما يلي: “يوري ستانديل، <وهو كاتب إسرائيلي> ونائب سابق لمستشار رئيس الوزراء عن القضايا العربية، يمنح زيادا لقبا بليغا وهو “الشاعر السام”، ويقول عنه الشاعر حاييم غوري “المزيج غير المحتمل من يسوع وستالين وعرفات”. ويضيف الصحافي يشوع بيصطور إن “عينيه تقدحان بشرارة الكراهية”.
ثم يدافع سوريك باعتدال عنه قائلا: “هذا الخوف الجماعي من زياد يعكس قلقا صهيونيا عميقا ولكن ليس له علاقة بكلام زياد، ولا أفعاله. وهذا الخوف من زياد محير. على اعتبار أنه يصور نفسه دائما كمواطن في الدولة ويطالب بالإصلاح وكقائد لأقلية قومية تطالب بحقها ضمن نطاق المواطنة-
حتى هنا لا أرى أي موقف واضح لكاتب السيرة، تامر سوريك، عن توفيق زياد موضوع كتابه. وأسأل نفسي: ماذا أتوقع من كتابه؟. يقدم تامر سوريك، وأسجل هذا له، مثالا ممتازا عما نتوقعه من باحث معجب ولكنه يخفي الأدلة. حتى أنه قال: “قابل الصحافي دافيد هاليفي توفيق زياد عدة مرات وقدم بروفيلا مفصلا ودقيقا عنه ولم يسبقه إليه أحد <نشرته مونيتين عام 1981>.. لمحرر مونيتين قدم باروخ أجندا واضحة تتحدى صورة زياد الراسخة بين الإسرائيليين اليهود. وأضاف للمقابلة شيئا من عندياته <ساخرا> من الفهم الإسرائيلي اليهودي الشائع عن زياد… ويبقى نص باروخ سخرية متواصلة من تمثيل الإعلام العبري لزياد طيلة سنوات آتية… <لاحقا> اكتشف صحافيون آخرون الهوة بين كاريكاتور زياد الأسطوري وشخصيته الحقيقية ورأيه في السياسة الدولية”.
وبصعود زياد التدريجي في الحزب، اتكأ على قاعدته الناصرية، ومن بينها بلدية المدينة، وجعل منها قاعدة قوة. وأطلق من هناك رسائله الملتهبة التي يخاطب بها عرفات والكنيست الإسرائيلي. وأمله بعقد صلح بين الإسرائيليين والفلسطينيين بوجود إسحاق رابين الجاهز لصفقة تكرم الأقلية الفلسطينية في إسرائيل وتمنحهم مشاريع محلية خاصة، سهل التعاون بين الاثنين بالرغم من الخلافات السابقة. ويحمل الآن أيمن عودة ممثل السياسيين العرب في إسرائيل، حذر زياد وخطواته المتأنية في الاقتراب من الحزب الصهيوني الذي يمكن التفاهم معه ولو أنه خارج الائتلاف الحاكم.
هذا التسييس، بحسب كلام زياد نفسه، شغله لدرجة أنه لم يترك له وقتا لكتابة الشعر. ومع ذلك، يقدم سوريك تفسيرًا بديلاً ومتواضعا يؤكد أن زياد تحدث بشكل مختلف إلى جماهير مختلفة، وأن الكنيست لا يمكنه أن يفهم شعره.
وهذا التكتيك مألوف بوجهيه الاثنين، وهو شائع بشكل خاص بين أفراد طبقتنا المثقفة، نحن المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، ولا سيما بين مجموعة كبيرة من خريجي جامعة حيفا والمختصين بالعلوم الاجتماعية. يضاف لهم أساتذة الفن الحديث مثل سامي سموحة وأرنون صوفر.
ويشكل هذا التقييم ضربة قاصمة لشخصية زياد، خاصة بمكانته الرائدة بين شعراء المقاومة الفلسطينية. وإذا وضعنا ذلك بالاعتبار، فإن تحليل المؤلف الذي يبدو بريئا ينقلب لعكسه. وكذلك الأمر بالنسبة لكلامه عن شعرية زياد، وأنها مجرد أداة في خدمة طموحاته السياسية.
واسمحوا لي أن أرى نوايا حسنة عند تامر سوريك كاتب سيرة توفيق زياد. وأنا شخصيا ممتن له. لكنه عجز عن تنظيف نفسه من التحيزات المسبقة “اليهودية الإسرائيلية” والافتراضات العدائية ضد كل ما هو فلسطيني.
وأقل ما يمكن أن يفعله كان زيارة عرابة وإعادة النظر بسمعتها “الشرسة” على أرض الواقع. ومن المرجح أن يدرك أنه في عرابة أعلى معدل من الأطباء لكل نسمة مقارنة بأي تجمع مدني في إسرائيل، سواء كان عربيًا أو يهوديًا. ويرى بعض زملائي من سكان عرابة أنني كنت أولهم. وأنا بدوري أرى أن الفضل يعود لأبي الأمين وزملائه من قادة الحزب الشيوعي. فقد وفروا الفرص المناسبة للشيوعيين المحليين الشباب وأوفدوهم إلى جامعات الاتحاد السوفيتي السابق ليحصلوا منها على المؤهل العلمي.