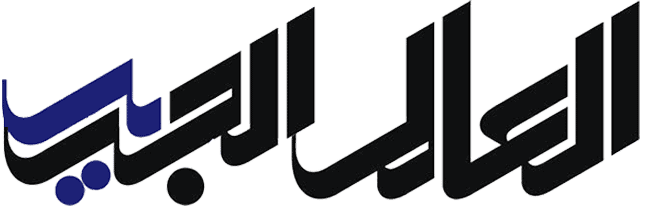المشترك الذي يمكنه جمع الناس بصرف النظر عن هوياتها هو الشعور بالوجود. ويتجلّى هذا الشعور على صورة بحثٍ مستمر نحو السعادة وتجنّب الألم. تجربتنا في تلمّس “نور” الوجود تبدأ من خلال الشعور، نتصل في هذا العالم من خلاله، إذ لا تجربة بلاشعور تماماً، ويتكوّن لدينا من هذا الجذر أحساس عميق بالهوية، ويتبرعم لاحقاً بأشكال قيمية واعتقادات شتى. شعورنا بالوجود يحرك فينا الكثير من الآليات الدفاعية، ومنها العطش اللامتناهي لكي نُوجَد و ننبثق ونتدفق ونمتد في هذا العالم. وعلى هذا المنوال يتجذّر فينا مبدأ السلامة والإحساس بالأمان كدرعٍ واقٍ لهذه الأنا وخوفها من التلف والضياع. فالخوف من فقدان ” يانصيب” الوجود هو علة العلل لكل مخاوفنا وأساطيرنا الفردية والجماعية، وماعداه يندرج في خانة الهوامش.
يصدف أن يجمعنا أقليم جغرافي يتمتع بتشكيلات تاريخية من المذاهب والأديان والأعراق، يمسك هذه التشكيلات المتعددة تاريخ مشترك من التضامن التاريخي، لأنهم عاشوا لأجيال في هذا الإقليم، وربما مرت بينهم صراعات متعددة، لكنها تنتهي على كل حال، ذلك أن التاريخ الدموي بين الشعوب، أو الجماعات التي تتشارك ذات الإقليم، هو نقطة الحسم الكبرى في إجراء الصلح، بتعبير آخر: يستحضر هؤلاء تاريخهم الدموي كمقدمة للتسامح والاعتراف لحفظ وجودهم لكي لا يتحولوا في متاحف التاريخ!.
التضامن الذي نتكلّم عنه يغترف من ينبوع الوجود، وبعبارة أوضح؛ إن أشكال التضامن التي نعثر عليها في أمة ما تترجم لنا ذلك الشعور العميق بالوجود، والابتعاد عن أي تهديد يمكنه اختراق ذلك الشعور فتنقلب المعادلة إلى موت محقق، فالموت هو “العدم” المهدد الذي يقطع صلة الكائن الإنساني بتنفس هواء الوجود، فيندفع الكائن البشري لتعميق روح التضامن مع الآخرين سواء بدافع نفعي محض أو لإدراك حقيقة التضامن، على اعتبار أن الكائن البشري اجتماعي بطبعه على كل حال.
صحيح إن التفاضل المتطرّف يذهب بعرق أو أمة نحو الأسطرة والمبالغات بنقاء هذا العرق وأفضلية هذه الأمة على تلك، (كما لو أننا خيول!) ومحاولة اختراع نقاط مرجعية وسجل حافل بالأساطير القومية والعرقية والدينية. لكن يبقى هذا التحدي (التفاضل) مسكون بالأنا الفردية، فشعور الأنا هو ذات الشعور بالوجود، ولكي تجد الأنا نفسها في دفاعات صلبة تنخرط في الجماعة لضمان ديمومتها، فبالتالي تنقل أساطيرها للجماعة، فتتحوّل هذه الأخيرة إلى أنا جماعية ضخمة تبالغ في تقدير ذاتها للحفاظ على مستويات وجودها التي تشعر بها. ويمكن القول من هذه الناحية، أن الشعور الجمعي هو حاصل عملية انتزاع جماعية من الأنا الفردية، أي انه يتدفق ، بعمومه، من ينبوع الأنا الفردية ثم يصب في نهر الشعور الجمعي لاحقاً. إنه حصيلة شعور الأفراد.
لا يعني إن الأنا الفردية تشعر بالذوبان الكامل في المجموع؛ فالسعي الحثيث للتميز والهروب عن كل ما يهدد الصفات الذاتية لهذه الأنا يجعلها تتصرف بالضد من المجموع في كثير من الأحيان للمحافظة على فرادتها المصطنعة، سواء بالتفرد الإبداعي الذي يقتضي الانسلاخ النسبي من فوضى الجماعة، أو بالأنانية المفرطة التي ترى نفسها أفضل من الغير حتى لو تطلب الأمر تهديد وجود الجماعة برمتها.
نحن أمام نمطين من الشعور بالوجود: وجود جماعي يضمن للانا وجودها المهدد من الآخر الغريب الذي لايشاركها أسطورتها الجماعية، ووجود فردي تحاول فيه الاعتزاز ببعض الخصائص للحفاظ على تفرّدها، أو بعبارة أخرى: على ما تبنيه من أساطير شخصية. ولكي تحافظ على وجودها تسعى الجماعات للدخول في مواثيق اجتماعية صلبة تنظم لها سبل العيش الكريم وتضمن لها وجودها بشكل منظم عن طريق مؤسسات الدولة التي تشكّل الحاضنة الكبرى للسلامة الأساسية للوجود البشري، لا بل هي من تقرر لهم وجودهم، متى يمكن الحفاظ عليه أو التفريط فيه؛ فعن طريق فض النزاعات تحفظ لهم وجودهم خشية أن يفتك بعضهم بعضاً، فـ” الإنسان ذئب لأخيه الإنسان” على حد تعبير هوبز.
غير أن الأنا الفردية تأخذها بعض الأشكال التعبيرية للتغوّل على الجماعة للمتاجرة بمصيرها بحجّة الانتصار للجماعة، وسيسجل لنا التاريخ الحديث والمعاصر، أن أشخاص مثل، هتلر، موسليني، ، وصدام حسين وغيرهم، المثال الأبرز لحالة تهديد الوجود البشري، فقد استطاعوا أن ” يبرهنوا” للآخرين الإمكانيات والمؤهلات التي تؤهلهم لحفظ وجود الجماعة، وقد ” سلّمت” هذه الأخيرة بهذه “البرهنة” المخاتلة فكانت نتائجها دماً ودموعاً.
غير أن هذه النماذج الأنفة تجد امتداداتها في جماعات تعتبر مفقساً لكل انماط التهديد؛ فيمكنك أن تذهب بحياة المئآة أو الآلاف من الأرواح البشرية، ويغدو وجودها بين يديك لمجرد أن تعزز فيهم غياب الأمان وفقدان الوجود، لكن النقطة الأكثر غرابة في هذا المثال، أن ذات الأفراد الذي يرعبهم زوال وجودهم سيخسرونه في نهاية المطاف! قرباناً لنقاطهم المرجعية وأساطيرهم الجماعية. وهذه المرة ستكون نقاطهم المرجعية هي الطائفة التي ينتمون لها. وعلى هذا الغرار ستفرّخ هذه الأساطير ” حماة” لهذه الأشكال الحميمية ونبدأ منازلة جديدة لتهديد الوجود.
لايوجد لدينا بديل خارق للعادة سوى ما أنتجته الخبرة البشرية من ضبط التلاعب بمقدرات الوجود البشري، عبر الإقرار بمسلمات وبداهات بشرية، ومنها الحق بالحياة!، وهذا الحق نابع -كما قلنا- من الشعور المتأصل بالوجود. حق الحياة يضمن لنا الانخراط بتجربة ثمينة ومهمة على مستوى الاجتماع والسياسة مفادها: مهما تجذّرت أساطيرنا، ومهما نسجنا زخارف أوهامنا، ومهما بالغنا بتقدير هوياتنا وانتماءاتنا، يبقى ذلك الشعور هم مشترك للكائن البشري، فلا طائفة ولا عرق أحق من الوجود من غيره، ماعلينا سوى الشروع لعقد اجتماعي يعمق فينا حالة التضامن بدلاُ من السقوط في محرقة العدم يوم لا ينفع المرء لا أساطيره الفردية ولا الجماعية، فالعدم يخترق كل هذه الأشكال ويحيلها إلى ذكريات مؤلمة لا يشرفنا نقلها إلى أبناءنا.