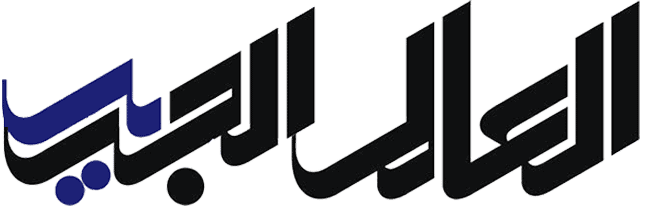أتذكر في بداية الثمانينات كان عموم الأهالي الذين ينحدرون من أسر فلّاحية ينظرون بارتياب لجهاز التلفزيون، وكانوا يصفونه بـ”الشيطان”. وقد عايشت هذه المرحلة وترددت على مسامعي كثيراً. لكن في بداية التسعينات تمت إزالة التلفزيون من لوائحنا السوداء!، ولم يعد في قاموسنا الرجيم، بل أضحى أحد الأجهزة المألوفة والمحببة لدينا واستطاع أن يحجز له مكاناً كأحد أفراد العائلة، والبيت الذي يخلو من هذا الجهاز كما لو أنه يخلو من حاجة ضرورية للغاية. وعلى الرغم من كل الأساطير التي نُسِجَت حول هذا المسكين!، فخلال عقد من الزمن استطاع التلفزيون أن يفرض نفسه ويخترق مروياتنا الأسطورية. أتذكر في يوم الجمعة كنت أنتظر كارتون “عدنان ولينا” بفارغ الصبر، وكانت “الفترة الدينية” الصباحية تصيبني بالنفور والتذمّر لأنها تزاحم متعتي، التي لا توصف، وأنا انتظر هذا “الحدث” الكرتوني المثير.
اليوم تشعّبت واتسعت أساطيرنا الاجتماعية وموروثنا الديني، بصيغته الشعبية، وواقعنا السياسي الذي يغذّي هيمنته من هذه الأساطير؛ فالسياسي اليوم لا يحتمي بمظلة القانون عموماً، وإنما بالمذهب والعشيرة، ومرجعياته المذهبية والدينية هي من تؤمّن له غطاءً شرعياً. وما بين هذا وذاك تأخذنا أحلام اليقظة بعيداً وتحلّق بنا رهاناتنا إلى عنان السماء؛ نحلم بدولة عَلمانية، نركّز على نقد الخطاب الديني والاجتماعي، ويعتقد بعضنا، ربما، على أهمية هذه الجهود لتوسيع رقعة الرأي العام وزيادة مساحة الحاضنة الشعبية لمثل هذه الأمور.
لا أحد يملك الجرأة لتسخيف هذه الجهود النبيلة، لكن قد نجادل من جانب آخر: سياق المرحلة ومخاطرها والمنطق السياسي القادر على تحقيق الأرضية الخصبة لهذه الثقافة، فحينما هيمن شبح الحروب الأهلية في أوربا نجد “توماس هوبز”، على سبيل المثال، يركز على إعطاء الملك صلاحيات مطلقة لحفظ السلم الأهلي؛ ذلك أن “الإنسان ذئب لأخيه الإنسان”، فبلا صلاحيات مطلقة للحاكم سوف تتجلّى حقيقة، “حرب الكل ضد الكل” كما يقول هوبز. ماذا يعني نقد الفكر الديني وتعرية أمراض المجتمع في ظل مقاومة اجتماعية تتسم بالعنف ضد التغيير؟ ربما سيحاجج بعضنا بحقيقة مفادها: وما المانع من تشجيع هذه الجهود كما لو أن هناك مبرراً للكف عن النقد؟ والجواب بالنفي بكل تأكيد، أعني لا مانع من ذلك، كما لا أحد يمتلك السطوة لتحديد ما ينبغي وما لا ينبغي، وحدها الأحداث والمخاطر من تحدد المنطق الذي يمكنه اختراق هذا الكابوس المرعب الذي يخيّم علينا. ربما الدماء والدموع ستكون خطوة مروّعة لتثبيت أسس النهضة!، وربما تأتي قيادة حكيمة، على غرار نموذج هوبز، أو محمد علي، مثلاً، لتقلب الموازين وتثبّت أسس السلم المجتمعي، وفي هذه الفترة بالذات لا تلتفت الناس كثيراً للمراجع الفكرية.
ينتقد ماركس رفاق دربه، اليسار الهيغلي، على نبرتهم الكفاحية وخطابهم الإلحادي العنيف ضد الدين (تصوروا ماركس الملحد ينتقد زملائه الملحدين على خطابهم المتشنج!)، ويوضح لهم أن الدين لا يكمن في السماء وليس فكرة تجريدية محلّقة بلا أساس مادي يرتكز عليه، وإنما يتموضع في مؤسسات ضخمة توارثتها الأجيال. فنقد الدين، من الناحية النظرية، لا يحقق الكثير، وإنما تكمن العلّة في إنشاء مؤسسات مدنية موازية تعادل المؤسسات الدينية، وتعمل على تعليم وتدريب المجتمع على مفاهيم مغايرة، وتضمن لهم الرفاه الاقتصادي والاجتماعي. هذا مثال بسيط عن الفكرة التي نحاجج من أجلها، من أن تأليف الكتب وحده لا يكفي، فالتغييرات الاجتماعية الضخمة يصحبها سياق اقتصادي وسياسي واستعماري!.
إن رفاه الشعوب الأوربية كان على حساب رفاهية باقي الشعوب؛ لابد أن تبقى القارّة الأفريقية، على سبيل المثال، مبادة ومعدمة ومحرومة من ثرواتها لضمان رفاهية الشركات الكبرى وثرائهم الفاحش. على أي حال، مع أهمية الكتب والمؤتمرات والحوارات، أراهن على التكنولوجيا في التغيير؛ فالمستقبل “بيدها” وهي من سيحدد نظامنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي ( شريطة عدم احتكار التكنولوجيا)، و ستعبر بنا إلى مناطق كانت مظلمة من قبل، مثلما استطاعت مواقع التواصل الاجتماعي التكلم عن المسكوت عنه، ومثلما استطاع التلفزيون تبرئة نفسه من الشيطنة المزعومة.