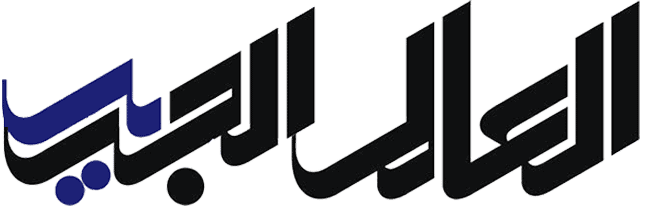لكثرة خيبات الأمل التي تعايشها الفقراء باتت الشعارات والوعود أمراً يثير الضحك. كيف تقنع فقيراً يسكن العشوائيات خرج ليقاتل بضراوة دون أن يلحظ تغييراً في حياته؟. ظلّت مدن العشوائيات كما هي ولم يتلّمس الفقراء تغييراً ولو طفيفاً في حياتهم، فقد عادوا لمزاولة مهنهم الذليلة والتي لا توفر لهم أدنى مستوىً يليق بكرامتهم البشرية. يبدو أن جماعة الخضراء مقتنعة كل الاقتناع بإبقاء كل شيء على حاله والحفاظ على هذا الجيش الهائل من الاحتياط ليكون متوفراً في أي محرقة مٌفتعلة أو حقيقية. المعضلة التي تجابه أغلبية الفقراء هو ضعف إدراكهم للعدالة الاجتماعية وتصوراتهم البسيطة حول توزيع الثروة.
على سبيل المثال، لا يدرك الشباب ذوو المهن الرخيصة أن قوة عملهم مهدورة ولا يمكنهم التفاوض على مهنة تليق بكرامتهم مستقبلاً لأنهم يفتقرون للمهارات اللازمة. كما لا يدركون فاعليتهم الحيوية في تحريك عجلة الاقتصاد ومراكمة الثروة ومشاركتهم في إرساء دعائم السلم المجتمعي. و المفارقة المؤملة هنا أن تصنيفهم من قبل الفئات المرفهة يأتي بعبارات حقيرة ودونية من قبيل ” غوغاء” أو ” قطيع. في المستقبل سيتم استغلال الفقراء بشكل مضاعف وسيتحولون إلى أدوات قتلِ رخيصة تحت هيمنة أمراء الحروب. في معركة داعش لم يشارك أبناء الأثرياء، وظلت الأحياء الراقية تستقذر الكلام عن هؤلاء المقاتلين الفقراء، وفي نهاية المطاف استحوذ أبناء” الباشوات” على المكانة الاجتماعية المميزة، يستنشقون نسيم الثراء المنعش ويرتادون المراكز التجارية ( التي بنيت بدماء الفقراء) ويقضون أيام الصيف اللاهبة في شمال العراق أو أحد الدول المجاورة، فيما يرابط أبناء العوائل المعدمة في جبهات القتال ثم يحصلون، بعد ذلك، على النطيحة والمتردية أو علم ملفوف على توابيتهم.
المصيبة أن فقرائنا يفعلون كل هذا وأكثر برحابة صدر وبلا مقابل، دون أن يحركهم شعور الوعي الطبقي كما لو أنهم مقدر عليهم الموت المجاني والفقر الذي لا يرحم. الكل يتآمر على هذه الفئة المغلوبة على أمرها؛ بداية من أمراء الحروب ووصولاً بالفئات المُرَفّهَة ونهاية بتآمرهم على أنفسهم!؛ يوم أعطوا أرواحهم بالمجان دون أن يطالبوا بحقوقهم المستلبة وهم الأغلبية الساحقة. من يشاهد حركة العمل في المناطق الشعبية سيتمنى لو عاد الزمن إلى الوراء ليترحم على أيام العامل في أوربا القرن التاسع عشر حيث كان العامل، على الأقل، يضمن له أجراً ثابتاً لقاء ساعات العمل الطويلة، بينما تخرج جحافل العتّالين صوب مراكز بيع الفواكه والخضار في منطقة جميلة وفي سوق” الشورجة” التجاري في قلب العاصمة وهم يجرّون عربات الحمل لبضائع التجار.
بالطبع، يمكن لنا مناقشة كل شيء سوى تمكين الفقراء؛ نناقش في المقاهي العلاقات الدولية، تاريخ الدبلوماسية، تاريخ فرنسا الثقافي، الرواية والشعر، العَلمانية الديمقراطية والليبرالية، وحقوق المرأة (هذه القضية تعذب قلوب الكثير).. كل شيء مطروح لطاولة النقاش في هذه الأماكن إلا قضية الفقر والفقراء وغياب الوعي بالفقر. طبعاً هنا “قوانة” جاهزة ومسلفنة وهي ” هؤلاء أغبياء ولا يعرفون مصلحتهم و”قطيع”، لكن حتى هذا القطيع، العزيز على قلوبنا، تحاول الدول جاهدةً لتنظيمه وتعليمه وتدريبه ولا تكتفي بحديث أهل المقاهي. مؤكد أن قضايا الفكر ليس عيباً في ذاتها وإنما عن الأولويات والمسؤوليات أتحدث.
والبعض الآخر يكتفي بحذلقات ثقافوية من قبيل: أن “الطبيعة” الثقافية لهؤلاء الفقراء ومنظومة القيم المهيمنة على وعيهم هي من تحدد نمط حياتهم، وهم، من هذه الناحية، آمنين مطمئنين لأحوالهم وأهوالهم. هذه ” اليقينيات”، وبشهادة عالم الاقتصاد والفيلسوف الهندي أمارتيا صن، لا تعدو أن تكون نظرات متسرعة تذكرنا بنظرة عالم الاجتماع الكبير ” ماكس فيبر” الذي أرجع أسباب تقدم المجتمع الأوربي لجذور ” بروتستانتية”، لكن فيما بعد تقدمت عملية التنمية في فرنسا ” الكاثوليكية” ليصحح الغربيون مقولة فيبر الشهيرة و”يكتشفوا” أن أسباب تقدم أوربا هي مسيحيتها الغربية!. بدت مقولة ” أوروبا المسيحية” سطحية وجوفاء نظراً لانتقال عملية التقدم في اليابان، إذ شهدت هذه الأخيرة حركة تصنيع هائلة قفزت بالمجتمع الياباني إلى مصاف الدول المتقدمة، فعندها انتقلت عدوى ” التميز الثقافي” إلى اليابان واستنتجوا أن أسباب التقدم في اليابان هي ثقافة “الساموراي”!. ثمّ لم يترك الصينيون ” مشاعية”هذه العدوى تدور في الفلك الياباني، فانتقلت إليهم، وظهر للصينيين أن التقدم الهائل الذي حصل في الصين كانت أحد مرتكزاته هي الثقافة “الكونفوشية”!. ينتقد أمارتيا صن هذه الأساطير ويعطي للتعليم والتدريب حصة واسعة في تطور أي مجتمع، فالموضوع لا ينحسر في ثقافة معينة، بل يتضامن الانفتاح الثقافي والتعليم لينتجا عملية تقدم في أي مجتمع كان. طبعاً، لم يشر أمارتيا صن إلى دور سياسات القوة العالمية المهمينة ودورها المحوري في عملية التنمية والتخريب، لكن هذا موضوع آخر ليس هنا محله.
وبالرجوع إلى قضية الفقراء، فأن الفقر في هذه الحالة ليس قدراً محتماً، ولا يرجع إلى الحيز الثقافي أو الموقع الطبقي؛ فالفارق، مثلاً، بين نسب التعليم المتدنية وارتفاع نسبة الفقراء في الرصافة مقارنةً بمنطقة الكرخ التي ترتفع فيها نسب التعليم وتدني نسب الفقر (تتعادل النسب في المناطق الشعبية في كلا المنطقتين)، راجع إلى سياسات القوة المهيمنة وتحكّمها بمصير الأغلبية لتحيلهم إلى فقراء. وبما إننا مهووسون بالنتائج دون البحث عن الأسباب التي تقف وراء ذلك، نحكم أن ” الشروكَية”، على سبيل المثال، لا يحبون التعليم ولا يهمهم وضعهم الاجتماعي المتردي ونستقذر الدفاع عن قضاياهم، لكن لا أحد يسأل: من أوصلهم إلى هذه النتيجة الكارثية؟. كيف يمكن لعائلة فلاح قادمة من الجنوب، تسكن في بيت لا تتجاوز مساحته144 م، ويفتقر لأبسط أسباب الشروط البشرية، أن يفكر أحد أبناءها بالتعليم ويخرج للدنيا ليرى أبواه يعملان في وظائف أقل ما توصف إنها تحتقر الكرامة البشرية؟.
هذا الشاب سينظر للواقع على أنه ” طبيعي” لأنه ولد في بيئة مرعبة لا تستوعب معنى التعليم من جهة، ولا تنظر إليه سوى مضيعة للوقت من جهة أخرى، لأن تعليمهم لا يوفر لهم لقمة الخبز، ولان الدولة حافظت على وضعهم الاجتماعي كما هو ولم تشركهم في عملية التنمية وترفع من مكانتهم الاجتماعية. كيف يمكن لفلاح غارق في قيمه العشائرية أن يثمّن عملية التعليم ما لم تنتشل الدولة أبناءه وتطور مهاراتهم وتزرع فيهم قيم المواطنة؟. تبقى المساحة التي ” يُعاتَب” عليها الفقراء في أنهم مصابون بداء الإيثار!؛أنهم يساهمون في رخائنا الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ويسهرون على حياتنا، حباً لرجال الدين! ولرجال السياسة ولأبناء العوائل المرفهة، وتبقى “تهمتهم” التي تطاردهم دائماً وأبداً: إنّهم فقراء لا يدركون مصالحهم.